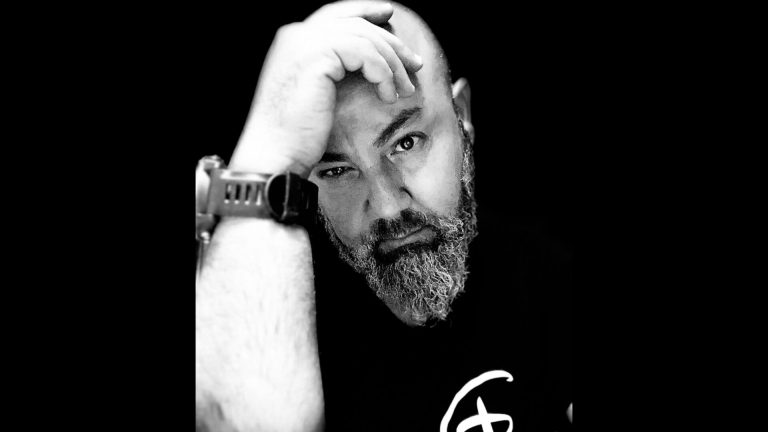د. محمد العماري//
يشكّل مشروع تعديل مدونة الأسرة المغربية لسنة 2025 لحظة مفصلية في مسار التشريع الأسري بالمغرب، خاصة بعد مرور أكثر من عشرين سنة على اعتماد نسخة 2004. ورغم ما حملته هذه الأخيرة من إصلاحات، فإن مآلاتها التطبيقية كشفت عن محدوديات بنيوية، دفعت اليوم نحو إعادة النظر فيها في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة يعرفها المجتمع المغربي. وبين من يراه خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية داخل الأسرة، ومن يعتبره مجرد إعادة إنتاج لإشكالات سابقة بصياغات جديدة، يُطرح التساؤل الجوهري حول طبيعة هذا الإصلاح المرتقب: هل هو قطيعة مع أعطاب الماضي، أم استمرار لها في سياقات جديدة؟
لقد شكلت مدونة 2004 تحوّلًا نوعيًا في منظومة التشريع الأسري المغربي، حيث أدخلت مفاهيم جديدة مثل “المسؤولية المشتركة للزوجين”، ورفعت سن الزواج إلى 18 عامًا، ووسّعت من إمكانية طلب الطلاق بالنسبة للنساء، وأقرت نوعًا من المساواة الرمزية داخل الأسرة. غير أن التغيير القانوني لم يواكبه تحول ثقافي ومؤسساتي كافٍ، إذ ظلت تطبيقات المدونة متأثرة بالبنية الذكورية للمجتمع، وبالممارسات القضائية غير المنسجمة، وبتفاوتات سوسيو-اقتصادية حالت دون تمتع النساء فعليًا بحقوقهن المكتوبة.
من منظور سوسيولوجي، يمكن تفسير ذلك بما أسماه بيير بورديو بـ”العنف الرمزي”، حيث تم توظيف القانون – رغم طابعه التقدمي – داخل منظومة ثقافية محافظة، مما أدى إلى تفريغه من مضمونه التغييري. وهكذا، ظل الحقل الأسري مجالًا تتقاطع فيه الهيمنة الذكورية مع ضعف الحماية المؤسساتية.
مشروع تعديل 2025 يعلن، من حيث الخطاب الرسمي، عن طموح لإصلاح شامل يتجاوز أعطاب التجربة السابقة، من خلال معالجة إشكالات الحضانة، النفقة، تقسيم الممتلكات، والسكن العائلي. ويأتي هذا في سياق اجتماعي متحول، يتميز بتزايد نسب الطلاق، وتغير أنماط الأسرة، وتنامي وعي النساء بحقوقهن، مقابل هشاشة ديموغرافية واقتصادية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
من بين المقترحات التي أثارت نقاشًا حادًا، تمكين المرأة المطلقة الحاضنة من البقاء في السكن العائلي. ورغم البُعد الإنساني لهذا المقترح، إلا أنه يفتح المجال أمام صدامات محتملة بين حقوق الحاضن (المرأة) وحقوق المالك (الزوج غالبًا)، خاصة في غياب سياسات سكنية واجتماعية داعمة. وفي غياب حلول هيكلية، قد يُنظر إلى هذا التدبير كمثال على ما تسميه نانسي فريزر بـ”العدالة التعويضية المؤقتة” التي تخفي غياب عدالة بنيوية.
تُظهر المقارنات الدولية في كيفية تدبير النزاعات الأسرية بعد الطلاق تنوعًا في النماذج التشريعية والمؤسساتية التي تعكس خصوصيات اجتماعية وثقافية واقتصادية مميزة. وفي سياق مشروع إصلاح مدونة الأسرة لسنة 2025، يطرح السؤال حول مدى إمكانية استفادة المغرب من تجارب دولية أكثر تقدمًا في هذا المجال، لا سيما النموذج الفرنسي والدول الإسكندنافية. غير أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تُفهم كعملية نسخ مباشر، بل ينبغي أن تُقارب كمحاولة لـ”الاقتباس السياقي” الذي يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات العميقة بين البيئات الاجتماعية والبنيوية.
في النموذج الفرنسي، يتم اتخاذ قرارات تتعلق بالسكن العائلي بناءً على تقييم اجتماعي شامل لكل حالة، وهو تقييم يُجريه مختصون في العمل الاجتماعي والنفسي، بتكليف من القضاء. وتُمنح الأولوية لاستقرار الطفل واستمرارية حياته الاجتماعية والتربوية، بحيث لا يُتخذ القرار اعتمادًا على مبدأ قانوني مجرد، بل على تشخيص واقعي لحالة كل من الطرفين وظروف الأبناء. ويستند هذا النموذج إلى وجود دولة اجتماعية ذات جهاز إداري فعال، ونظام متكامل من الدعم السكني والمرافقة القانونية، وآليات فعالة لتدخل الدولة في الحالات الهشة.
أما في الدول الإسكندنافية، فتُعتمد فلسفة تقوم على “العدالة التشاركية”، حيث يتم تقاسم المسؤوليات الاقتصادية والتربوية بين الأبوين بعد الطلاق، مع توفير دعم مؤسساتي يضمن للمرأة والأطفال الاستقلال والاستقرار. ويشمل هذا الدعم خدمات المرافقة الاجتماعية، والإعانات المباشرة، وبرامج السكن المؤقت، إضافة إلى نظام قضائي مرن يستند إلى مبادئ الحماية والرعاية الشاملة. إن هذا النموذج يتغذى على ثقافة سياسية واجتماعية ترى في الرعاية المجتمعية جزءًا من مسؤولية الدولة، وترتكز على بنيات دولة الرفاه.
غير أن الفارق الجوهري بين هذه النماذج والمغرب يكمن في السياق الاقتصادي والديموغرافي والسياسي. فالمغرب يواجه تحديات متعددة: من جهة، توجد هشاشة مزمنة في نظام الحماية الاجتماعية، وندرة في الموارد العمومية المخصصة للسكن والدعم الأسري، ومن جهة أخرى، تعيق التقاليد الاجتماعية والثقافية التحول نحو مقاربات أكثر تشاركية في تدبير الحياة الأسرية بعد الطلاق. كما أن ضعف التنسيق بين الجهاز القضائي والمؤسسات الاجتماعية، وانعدام التكوين المهني الكافي للعاملين في المجال الاجتماعي، يجعل أي استنساخ حرفي لهذه التجارب الأجنبية عرضة للتعثر والفشل.
وعليه، فإن التفكير في إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يتم ضمن رؤية شاملة تتجاوز البُعد القانوني، لتطال إصلاح السياسات الاجتماعية، وبناء مؤسسات الوساطة، وتكوين الأطر، وتوفير السكن الاجتماعي، ومرافقة النساء المطلقات نحو الاستقلال الاقتصادي. كما يتعين استحضار البنية الذهنية والثقافية للمجتمع المغربي، وتطوير مقاربة إصلاحية هجينة تجمع بين العدالة الاجتماعية ومراعاة الخصوصية المحلية، بما يضمن تفعيلًا واقعيًا وفعّالًا للنصوص القانونية.
تُعدّ مدونة 2025 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة المغربية على الانتقال من “التحديث القانوني” إلى “الإصلاح الاجتماعي المتكامل”. ويقتضي ذلك تجاوز المقاربة القانونية الضيقة نحو تبني مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب الاقتصادية (تخصيص مساكن اجتماعية للمطلقات)، التكوينية (برامج إدماج وتأهيل مهني)، والنفسية (مرافقة الأطفال والنساء في مرحلة ما بعد الطلاق). كما يستدعي هذا الإصلاح استحضار البعد المجالي، فالتفاوتات الجهوية في تطبيق مدونة 2004 كانت جلية، بين وسط حضري منفتح ووسط قروي محافظ. لذا، فإن العدالة المجالية في تطبيق الإصلاح تُمثّل ركيزة أساسية لضمان فعاليته.
من الناحية النظرية، يمكن الاستناد إلى نظرية جون رولز حول “العدالة كإنصاف”، لتأكيد ضرورة توزيع الحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة بطريقة تراعي هشاشة الفئات الأضعف دون الإخلال بمبدأ الإنصاف بين الأطراف.
إن مشروع تعديل مدونة الأسرة لسنة 2025 يحمل في طياته وعودًا بإصلاح حقيقي، لكنه في الآن ذاته يواجه خطر السقوط في فخ إعادة إنتاج نفس الأعطاب البنيوية التي شابت تجربة 2004، إذا لم يُدمج في رؤية شاملة تستند إلى العدالة الاجتماعية، والتوازن بين الحقوق والواجبات، وتحيين الثقافة القانونية والقضائية.
وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بنصوص التعديل، بل بمدى توافر إرادة سياسية ومجتمعية لإعادة صياغة الحقل الأسري على أسس أكثر عدالة واستدامة. وإلا، فإن التعديل قد يتحول من فرصة تاريخية إلى مجرد مسكن قانوني لإشكالات بنيوية عميق